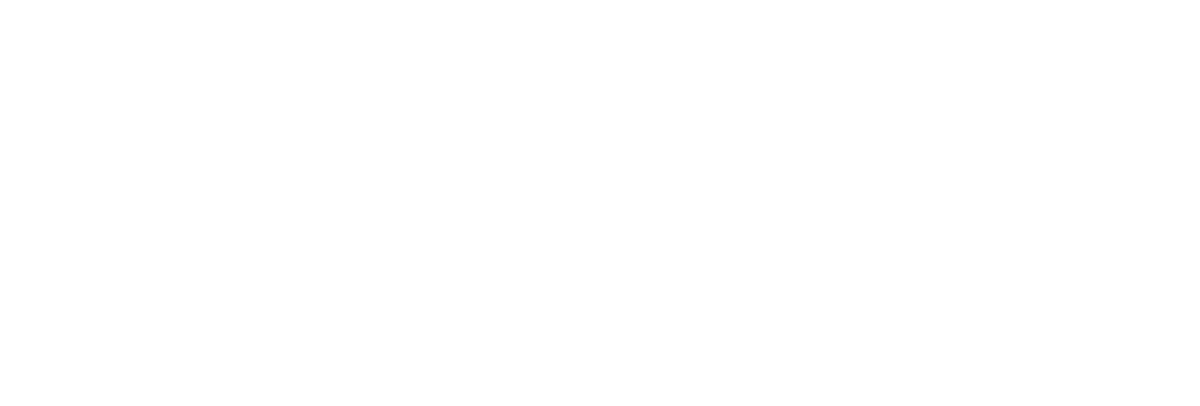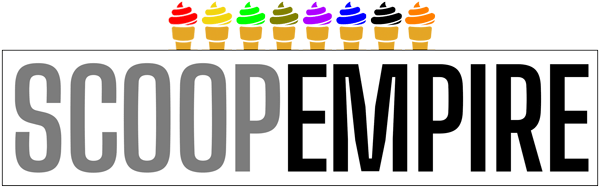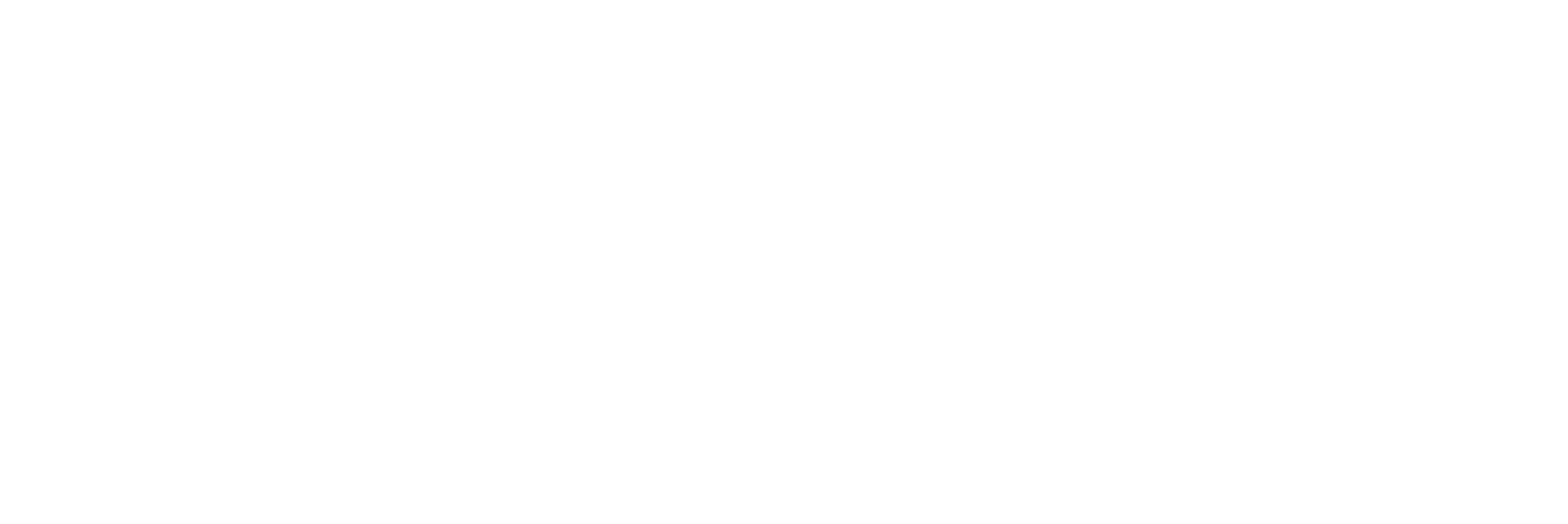في إحدى الليالي البيروتية المتعبة، وبين سجائر منطفئة وأكواب قهوة باردة، جلس زياد الرحباني وحيدًا، يحدّق في آلة البيانو كأنها مرآة. لم يكن يبحث عن لحن، بل عن نفسه.
في الخارج، كانت المدينة تمشي متثاقلة على أنغام أغنياته، تهمس بكلماته في الأزقة، وتردد موسيقاه بين زجاج السيارات. أما هو، فكان يكتب وجعه كمن يكتب وصيته الأخيرة.
الابن الذي حمل اسم الرحابنة لكنه رفض أن يلبسه كعباءة جاهزة، والموسيقي الذي روّض السياسة على المسرح، وسخر من الحرب حتى صارت نكتة.
هو العاشق الذي كتب أجمل أغاني الحب ولم يعترف بالحب، والساخر الذي أضحك جيلاً كاملاً وهو يغرق بصمته. عاش زياد في الزوايا المعتمة من الحكاية، بعيدًا عن التصفيق، أقرب إلى الجرح، أقرب إلى الحقيقة.
في هذه الرحلة، لن نروي سيرة فنية فقط، بل سيرة رجل عاش متعبًا، صادقًا، مندفعًا، وغريبًا… زياد الرحباني، كما لم يُروَ من قبل.
“دايمًا في الآخر في وقت فراق”
زياد الرحباني
لا تفوّت قراءة: الفطور المصري زمان: حين كان “كيك البرتقال” أجمل من الـ”ماتشا لاتيه” و”ترافل بالبستاشيو”
كيف اكتشف عاصي الرحباني موهبة ابنه زياد؟

في منزلٍ تتنفس جدرانه موسيقى، لم تكن أسئلة زياد الرحباني لوالده عاصي جزءًا من فضول عابر، بل إشارات مبكرة لموهبة فريدة.
كان الطفل يقطع واجباته المدرسية ليبدي رأيه في ألحان والده، فيسأله عاصي: “هل أعجبك هذا اللحن؟”، وينتظر ردًا جادًا.
زياد، رغم صغر سنه، كان يجيب بثقة، ويقترح تعديلات على مقطوعات تُصنع في بيتٍ لا يرضى بأقل من الكمال الفني.
وذات مساء، دندن زياد لحنًا جديدًا وهو يتابع واجباته، فاستوقفه عاصي، مذهولًا من النغمة التي خرجت دون سابق إنذار.
سأله الأب بدهشة: “أين سمعت هذا اللحن من قبل؟”، فأجابه زياد ببساطة: “لم أسمعه قط، بل هو يتردد في رأسي منذ فترة”.
في تلك اللحظة، أدرك عاصي أن ما يملكه ابنه يتجاوز التذوق الموسيقي، ليبلغ حدّ الخلق والإبداع الفطري.
هكذا، بزغت موهبة زياد في قلب بيتٍ يتقن الإنصات، وتيقّنت العائلة أن الفن ليس امتدادًا فقط، بل ولادة جديدة لعبقرية لا تُشبه أحدًا.
كان حلمي طير .. قام طار حلمي
زياد الرحباني
“صديقي الله”: ديوان طفل عبقري فاجأ الكبار

لم يكن زياد الرحباني طفلًا عاديًا، ولم يكن الفن في حياته مجرد إرث عائلي، بل نافذة مبكرة نحو عالمه الداخلي العميق.
في سن الثانية عشرة، كتب ديوانه الشعري “صديقي الله”، ففاجأ به الكبار قبل أن يُدهش أقرانه. ديوان صغير في حجمه، لكنه يفيض بنضج غير مألوف، وبأسئلة لا يطرحها عادةً من لم يعبر بعد عتبة الطفولة.
كتب عن الحب والموت والله، وعن الحياة كما لو أنه اختبرها في حياةٍ سابقة، أو رآها تتكرر أمام عينيه دون توقف. وظهرت الأم في قصائده ككائن ضوئي، طاغي الحضور، فيما بدا الأب كظلٍ بعيد، ساكنٍ في الخلفية.
وفي إحدى أبياته، تمنى أن يعرف والداه أن “الفرح أقوى من الحزن، وأن العتاب كالدخان… يفنى ولا يعود”.
بهذا الوعي الحاد، أعلن زياد أن الكلمة ليست لهواً، بل شهادة مبكرة على عبقرية تتكوّن في صمت، وتكبر بين السطور.

هل سمعت يومًا القصة الحقيقية وراء “سألوني الناس”؟
هي ليست مجرد أغنية شهيرة، بل مرآة لحظة إنسانية نادرة، كانت بداية لمسار فني غير متوقَّع.
في عام 1973، أُصيب عاصي الرحباني بوعكة صحية ألزمته المستشفى، تاركًا فراغًا فنيًا وإنسانيًا في حياة فيروز. وتزامن ذلك مع استعداد فيروز لتأدية دورها في مسرحية “المحطة”، بينما كان القلق يثقل أيامها.
في تلك اللحظة، كتب منصور الرحباني كلمات أغنية تعبّر عن غياب عاصي، لتغنيها فيروز من قلبها لا من النص فقط.
لكن المفاجأة كانت في اللحن؛ لم يأتِ من عاصي، بل من ابنه زياد، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط. وبدافع من الحزن والحب، لحن زياد الأغنية بصمتٍ مؤلم، ليكون هذا أول عمل يقدمه لوالدته، في أول ظهور فني حقيقي له.
غنّت فيروز “سألوني الناس” بصوت الحنين، بينما كانت تغني – للمرة الأولى – من ألحان ابنها. وتحوّلت الأغنية إلى نشيد للذكريات، وباتت بوابة عبور زياد إلى عالم الأضواء، ليس كابن الرحابنة فقط، بل كصوت مستقل.
ما بدأ كلحن صغير في لحظة ألم، أصبح حجر الأساس لمسيرة موسيقية غيرت وجه الأغنية العربية.

لا تفوّت قراءة: افتكاسات المانجو: نكهات جديدة لعشّاق المغامرة لن تخطر على بالك!
“كيفك إنت؟”: أغنية وُلدت من وجع أم وغياب ابن
لم تكن “كيفك إنت؟” مجرد أغنية، بل رسالة غير مكتوبة بين أمٍ تنتظر، وابنٍ ابتعد دون وداع. وبعد أن غادر زياد لبنان، تزوج، وابتعد بصمت، التقت به فيروز صدفة، وكانت لحظة مشحونة بالمشاعر المتداخلة.
قالت له بعفوية تفيض أمومة وعتبًا: “كيفك إنت؟ عم بيقولوا صار عندك ولاد، وأنا مفكرتك براة البلاد”. تلك الكلمات البسيطة بقيت ترنّ في أذن زياد، وتحولت لاحقًا إلى قصيدة من لحم ودم، كتبها ولحنها بنفسه.
وحين قدمها لوالدته، رفضت فيروز غناءها بدايةً، ربّما لأن الكلمات كانت أقرب إلى القلب من أن تُقال بصوت. لكن في ليلة مقطوعة الكهرباء، جلس زياد وغنّاها لها على ضوء شمعة، كما لو أنه يعترف بخطأٍ لا يُقال.
استمعت فيروز بصمت، بين ضوء خافت وذاكرة لا تُطفأ، ولم تقل شيئًا، لكن الأغنية بقيت معها. وبعد أربع سنوات، وتحديدًا في عام 1991، قررت فيروز أن تغنيها، وتمنحها مكانها الحقيقي على المسرح.
غنّتها كما كُتبت: بصدق، ووجع، وعاطفة أمٍ غفرت، فأصبحت “كيفك إنت؟” واحدة من أكثر أغانيها قربًا للقلوب. هكذا، تحولت لحظة شخصية عابرة إلى عمل خالد، يجسد الحب حين يكون صامتًا، لكنه عميق إلى حدّ لا يُحتمل.

لا تفوّت قراءة: حين يُروى الأدب بالكاميرا.. 7 روايات عربية تحولت إلى مسلسلات وأفلام
زياد الرحباني في “المحطة”: أول ظهور مسرحي وولادة صوت جديد
لم يكن ظهوره الأول عاديًا. كان زياد الرحباني على المسرح لأول مرة، إلى جانب والدته فيروز، في مسرحية “المحطة”. ولعب دور الشرطي، لكنه لم يكتف بالتمثيل فقط، بل ترك بصمة موسيقية لا تُنسى في خلفية العرض.
كتب موسيقى المقدمة، التي فاجأت الجمهور بإيقاعها المختلف، وجرأتها على كسر القوالب التقليدية. وشعر الحاضرون بأن شيئًا جديدًا يولد على الخشبة، صوت شاب يُعيد رسم ملامح المسرح الرحباني.
كانت تلك اللحظة إعلانًا صامتًا بأن الجيل القادم قد وصل، لا ليُقلّد، بل ليُحدث فرقًا. زياد لم يأتِ ليكمل مسيرة أبيه وعمه فقط، بل ليبدأ حكايته الخاصة، بلحنٍ وصوتٍ وجرأة.
المسرح… والصوت الذي لا يسكت: زياد الرحباني في وجه الصمت
منذ خطوته الأولى على الخشبة، اختار زياد الرحباني أن يكون الصوت العالي في زمن الهمس، والوجه الساخر في زمن الأقنعة.
انحاز للمسرح السياسي الساخر، لا كتجربة فنية، بل كموقف شخصي صريح لا يعرف المواربة. كتب، وأخرج، وأنتج أعمالًا تُشبهه: حادة، صادمة، وغارقة في واقعية لا تجامل أحدًا.
من “سهرية” إلى “نزل السرور”، ثم “بالنسبة لبكرا شو” و”شيء فاشل”، وصولًا إلى “فيلم أمريكي طويل”… تنقّل زياد بين وجوه لبنان المتعبة.
كانت كل مسرحية بمثابة مرآة، لا تعكس الشكل فحسب، بل تكشف القبح الذي تعوّد عليه الجميع. لم يكن على الخشبة فحسب، بل في قلب الناس، يقول ما لا يجرؤون على قوله، ويضحكهم من وجعهم.
تحوّلت مسرحياته إلى ساحة اعتراف، وتشريح جماعي للخيبة، ومتنفّس علني لأصوات المهمشين. ضحك الجمهور، نعم، لكنهم بكوا أيضًا، لأن في كل نكتة مرّة… حقيقة أكثر مرارة.
لا تفوّت قراءة: من “بشرة خير” إلى “حبيبي بالبنط العريض”.. أفضل 10 أغانٍ لا تُنسى لحسين الجسمي
زياد الإذاعي… حين صار الصوت مأثورًا
بعيدًا عن ضوء المسرح، اقتحم زياد الرحباني أثير الإذاعة، لا كمذيع تقليدي، بل كصوت ناقد، ساخر، ومتمرد. وخلال الحرب الأهلية اللبنانية، لم يصمت، بل استخدم الميكروفون كمنبر للوعي والضحك في آن.
قدّم برامج إذاعية مثل “بعدنا طيبين… قول الله”، و”نص الألف خمسمية”، و”العقل زينة”، فصار حديث الناس. وكانت تعليقاته سريعة، لاذعة، تلتقط العبث السياسي وتحوّله إلى نكتة تحمل الحقيقة على طرفها.
تحوّلت عباراته إلى مأثورات يومية، يتداولها الناس كأمثال تصف حال لبنان والعرب بدقة موجعة. زياد لم يروِ الأخبار، بل روى وجع الناس، كما هو، دون تزييف أو تهذيب.
زياد الرحباني والنساء: حين يتحوّل الحب إلى نيران مشتعلة
لم تكن حياة زياد الرحباني العاطفية سهلة، ولا قصصه تشبه النهايات السعيدة. الحب في حياته كان صاخبًا، معقّدًا، ومشتعلًا حتى الرماد.
كان يقول عن نفسه: “أنا وقح وجلخ”، لا يجمّل شيئًا، ولا يعتذر عن مشاعره، حتى حين تتكسّر.
عاش قصة حب طويلة مع الممثلة اللبنانية كارمن لبُس، استمرت خمس عشرة سنة، ثم انتهت بخيبة علنية. ولم يلجأ للصمت، بل كتب أغنية “ولّعت كتير”، كأنها اعتراف أخير ومحاكمة بالعاطفة:
“ولّعت كتير… خلّصت الكبريتة
لا إنت الزير… لا إني نفرتيتي”
أما طلاقه من دلال كرم، فترك جرحًا آخر، لكنه لم يداوِه بالصمت، بل بردٍّ موسيقي ساخر. وكتب أغنية “مربّي الدلال”، التي أدّاها صديقه جوزيف صقر، وجعل منها هجاءً شخصيًا لا يرحم.
كانت الأغنية ردًا غير مباشر على اتهامات دلال له بالخيانة والإدمان، فاختار أن يحوّل وجعه إلى فن لاذع.
هكذا أحب زياد… بشراسة. وعندما انتهى، لم يكتب وداعًا، بل كتب أغاني تبقى مشتعلة حتى بعد أن تنطفئ العلاقة.
لا تفوّت قراءة: هل كان الطريق إلى الشهرة يبدأ بـ95%؟ اكتشف درجات نجوم الفن والرياضة في الثانوية العامة
حكاية أغاني كتبها زياد الرحباني من أجل… سيارة!

رغم انتقاده الحاد للفن التجاري، لم يكن زياد الرحباني بمنأى عن الحاجة، خاصة في أيام الحرب الأهلية القاسية. وفي إحدى تلك اللحظات، راقت له سيارة، لكنه لم يكن يملك ثمنها، وكان بحاجة إلى ثمانية آلاف ليرة.
لجأ إلى عمه إلياس الرحباني، الذي كان يشرف على برنامج “ساعة وغنية” في إذاعة الأردن. واقترح عليه إلياس تلحين عدد من الأغنيات للبرنامج، لكن دون توقيع اسمه كمؤلف، مقابل أجر مباشر.
زياد لم يعترض، بل سأل: “كم أغنية تريد؟”، فرد إلياس بسؤال: “ولِمَ بالضبط ثماني ألحان؟”. وأجاب زياد ببساطة ساخرة: “عشان بدي أشتري سيارة!”، وهكذا وُلدت الألحان من رغبة شخصية جدًا.
ثماني أغانٍ، لا تحمل اسمه، لكنها تحمل لمسته الموسيقية بوضوح، وكانت أولى تنازلاته المؤقتة أمام ضرورات الحياة.
لا تفوّت قراءة: من هم؟.. 9 رؤساء تنفيذيين مصريين بين الأقوى في الشرق الأوسط
“بلا مخ”: فلسفة السعادة على طريقة زياد الرحباني
في لحظة صدق عفوية، قال زياد الرحباني جملة صادمة: “السعادة؟ إنك تعيش بلا مخ”. لم يقصد الغباء، بل التحرر من التحليل، القلق، والهمّ الوجودي المزمن.
السعادة، في نظره، لا تحتاج فلسفة، بل تحتاج فقط إلى أن تترك رأسك يرتاح قليلًا. أن تعيش اللحظة كما هي، دون مراجعة، دون جلد ذات، ودون بحث عن المعنى دائمًا.
وجدها في أغنية مرتجلة، أو نكتة عابرة، أو كوب شاي في استوديو مهمل. وكانت تلك اللحظات غالبًا بصحبة رفاقه اليساريين، حيث كانت البساطة موقفًا، لا خيارًا مؤقتًا.
زياد لم يروّج للوهم، بل للهدوء الذي يمنحك أنفاسًا وسط ضجيج الحياة اليومية.
“إلى عاصي”: وفاء أخير من الابن للغائب الأب
في عام 1995، عاد زياد الرحباني إلى الجذور، لكن بطريقته الخاصة، من خلال ألبوم “إلى عاصي”. كان الألبوم تحية موسيقية لروح والده عاصي الرحباني، الذي شكّل وجدان جيلٍ كامل.
ضمّ الألبوم 18 أغنية من تراث الأخوين رحباني، أعاد زياد توزيعها برؤية موسيقية جديدة. جمع بين الطابع الشرقي الأصيل ونفَس الجاز الحرّ، فخلق مساحة إبداعية لا تشبه إلا زياد.
لم يكن إعادة إنتاج، بل إعادة ولادة، بأدوات العصر وروح الابن المتمرّد. وحافظ على الجوهر، وغيّر الشكل، ليمنح الجمهور نكهة مألوفة بنَفَس حداثي نابض.
“إلى عاصي” لم يكن مجرد ألبوم، بل فعل حب متأخر، ووفاء صامت لا يحتاج إلى كلمات.
لا تفوّت قراءة: المسلسل الأبرز على نتفليكس.. لماذا يجب أن تضيف “كتالوج” إلى قائمة مشاهداتك فورا؟

وداعًا زياد… لا وقت بعد الآن للفراق
“أنا كل القصة، لو منكن ما كنت بغنّي… ودايمًا بالآخر في وقت فراق”، هكذا قالها زياد، بلسانه، وبقلب فيروز. واليوم، لم يبقَ للغناء مكان، فقد جاء وقت الفراق فعلًا، ولكن ليس كأي فراق.
رحل زياد، وترك خلفه فراغًا لا يُملأ، وصوتًا لا يُكرَّر، وروحًا لا تشبه إلا نفسها. ولم يأخذ معه جسده فقط، بل أخذ جزءًا من ذاكرة لبنان، بكل ما فيها من وجع ونغم.
غادر بصمته، كما عاش بصخب، تاركًا موسيقى لا تجامل، ونصوصًا تلسع، وضحكات تحمل مرارة الحقيقة. لم يكن فنانًا عاديًا، بل حالة… مدرسة في الجرأة، وفي الصدق، وفي كسر القواعد.
وداعًا زياد، لن نبحث عنك في المسرح ولا في الإذاعة، بل سنسمعك في صمتنا، حين نكون نحن.